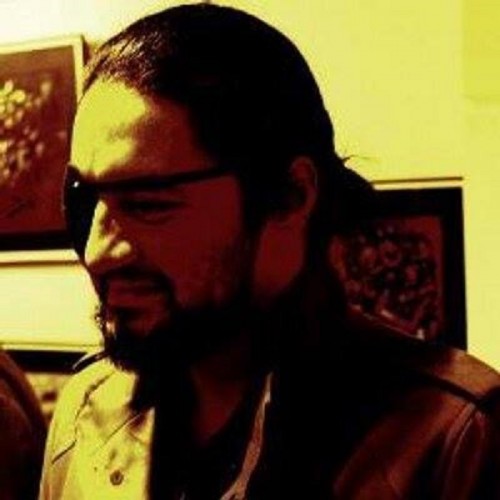يقول ستلمان، إحدى شخصيات رواية \”مدينة الزجاج\” للروائى الأمريكى \”بول أوستر\”:
\”كانت إحدى مهام آدم فى الجنة خلق اللغة، وإعطاء كل خلق وشئ اسمه، كان لسانه ينطلق مباشرة إلى قلب العالم، ولم تكن كلماته مجرد لواحق بالأشياء التى يراها، وإنما كانت تكشف جوهرها وتبعثها إلى الحياة. وكان الشئ واسمه مرادفين أحدهما للآخر.. ثم يضيف: \”وبعد السقوط، تغير الحال، فقد انفصلت الأسماء عن مسمياتها وتحولت الكلمات إلى مجموعة من العلامات التعسفية، وانفصلت اللغة عن الخالق، ولذلك فإن قصة الجنة لا تسجل سقوط الإنسان وحسب، بل سقوط اللغة كذلك\”.
ألا يمكننا الدفاع عن \”البذاءة\”، بقولنا لمن يعتبرونها \”خطيئة\”، أنها ربما كانت خطيئة بنى آدم الضرورية أو الواجبة لمحو نتائج الخطيئة الأولى لآدم؟ لإمكانية الربط بين الدال والمدلول؟ للاستعادة المستحيلة لحالة البراءة التى كانت موجودة قبل \”السقوط\”، حين كان الشئ واسمه واحدا؟ أو لمقاومة تلك الاستحالة؟ \”خطيئة\” خلقتها الحاجة إلى النفاذ لقلب العالم والأشياء.
تحت سلطة مراقبة اللغة يتم دمغ كلمات بصفة \”البذاءة\” من قِبل حراس الخطاب. وتخلق لغة مجتمع السيطرة عالما مغلقا من الإنشاء أو التعبير، تدور فى فلكه مؤسسات البحث والإعلام والدعاية ومكاتب الإدارة وخطب الساسة، كما تحدد ما يجب أن يُكتب أو يقال وما يجب إقصاؤه أو تهميشه.
تتجلى البذاءة فى الفن والحياة بوصفها أداة نفى، وما تفعله العامية والتعابير البذيئة هو التصدي بسخرية مثيرة للكلام \”الرسمى\” و\”الأدبي\”. وكما يوضح هربرت ماركوز فى عبارات دالة:
\”وكأن الناطق الغفل بلسانه يؤكد إنسانيته فى لغته بوضعه إياها على قطب معارض للسلطات القائمة، وكأن الرفض والتمرد الذين تمت السيطرة عليهما على الصعيد السياسى ينفجران فى مفردات تسمى الأشياء بأسمائها\”.
لذلك أينما وليت وجهك فثمة تجلى للبذاءة..
انتشرت أثناء المظاهرات اللبنانية الأخيرة صور لافتات يحملها الشباب والفتيات، تعبر ببساطة عن فقدان الثقة فى الساسة ورجال الدولة، كنتيجة منطقية لتاريخ طويل من الخيانة والنفاق.. حملت اللافتات كلمات مثل:
\”مش مزبوطة.. يحكمونا ولاد شرموطة\”.. \”ما تصدق النائب ولو نزل مصه\”.
وفى الثورة المصرية انتشرت الشتائم فى أناشيد الأولتراس، وعلى جدران المدن، لكن الضمير المحافظ لأخلاق المجتمع (وخاصة الطبقة الوسطى) كان يسارع دوما لإدانة \”الألفاظ\” متجاهلا الدماء والقتل المجانى المنتشر فى غالبية المدن.
وفى مشهد شديد العبثية، سارعت تيارات الإسلام السياسى فى مصر (والتى كانت ولا زالت قرينة الاستبداد والقمع) إلى التأصيل الفقهى البرجماتى للبذاءة، من أجل تدشين حملة مضادة للرئيس الحالى أثناء فترة الانتخابات الرئاسية: تحت عنوان \”انتخبوا العرص\”.
وعلى صعيد الثقافة، يتجاوز الأمر مجرد الرغبة فى حرية التعبير، فالتوظيفات الفنية للبذاءة تكشف عن نقد للمفاهيم والبنى التى تشكل أسس التفكير فى عالم اليوم، ورغبة فى تحرير البذاءة من السياق الاضطهادى الذى أوجدته السلطة لها، وإذا افترضنا أن \”المجاز\” كان هو محور النزاع القديم فى الثقافة العربية والإسلامية، فالبذاءة هى \”البؤرة الصراعية\”- بتعبير شريف يونس- الجديدة، خاصة فى العقود السابقة، فهى الذريعة التى يتم بموجبها المنع والحظر والمحاكمات.
الروائى والصحفى المصرى أحمد ناجى داخل السجن الآن.. التهمة هى اختياره للطريقة التى يريد أن يكتب ويتكلم بها.. اللغة، تلك الملكية المشاعية، يحاول البعض احتكارها وخصخصتها.. ابتسم أنت الآن فى عصر محاكم التفتيش الجديدة.. مرحبا بك.
يحاولون مداراة القبح والقهر والظلم والدماء بورقة التوت الأخيرة: الأخلاق.
وكلما تحدث أحدهم عن الأخلاق تحسست \”بضانى\”.
ولكن، يا من تقدمت بالبلاغ، ألا يخدش القتل حياءك؟ ألا تلطخه الدماء؟.. طيب.
كتب أحمد ناجى فى مقال سابق له عن \”التنوير الكاكي\”، كما كتب المفكر نصر حامد أبو زيد فى مقاله الهام والشهير\”سقوط التنوير الحكومى\” (والذى نُشر فى أخبار الأدب عام 2007). والخلاصة: الدولة المصرية دولة ثيوقراطية عسكرية، ومفاهيم كالمواطنة والحرية والعلمانية هى للاستعمال الشخصي، كلينكس يُلقى به في مراحيض أخلاق الفاشية.
فى رواية (استخدام الحياة)، يمارس ناجى حريته، وتنطلق فرديته. وقد كتبت من قبل مقالا نقديا عن الرواية ونشر فى جريدة أخبار الأدب يونيو 2015.. حاولت فيه أن أوضح الطبيعة الثورية لهذا العمل الفنى، وعنونت المقال: \”الفن كفعل ثورى\”:
\”تسعى استخدام الحياة إلى تطويع الثقافة الجماهيرية التى تم تسليعها وثقافة \”البوب آرت\”، وكثير مما تم اقصاؤه خارج نطاق \”الأدبية\” أو \”الأدب الرفيع\”، لانتاج عمل فنى مستقل فى النهاية. يبدى علائم الاستقلال من حيث قدرته على تخطى الشروط التى أنتجته والمعطيات التى شكلته، ويتسم بصفة هدامة تتحدى الوضع القائم ولا تكتفى بمجرد التعبير عنه\”.
وأنهيت كلامى كالآتي:
\”يؤكد الكاتب الأفريقى الكبير \”وثيونجو\” أن \”الفن فعل ثورى\”، والصراع الذى وصفه بين الفن والدولة يجد صداه فى \”استخدام الحياة\”: \”الصراع بين قوة أداء الفن وبين أداء قوة الدولة\”.
وما تحاوله الرواية هو التحرر من القبضة المحكمة على الكتابة، وتستعين بقوة الفن النافية على كل القوى التى تحاول إفساد الفن.. والحياة\”.
الصراع كان حتميا، حتى وإن اتخذ شكلا هزليا.. لا يلهينا العبث القائم عن جوهر ما كتبه وفعله ناجى.. اختار أحمد ناجى أن يحضر جلسة المحاكمة مهما كانت التبعات، وهو مدرك للصراع المجتمعى الذى ينبغى خوضه من أجل حرية التعبير والإبداع، ومستعد لدفع الثمن المطلوب لذلك، فى توحد مذهل بين القول والفعل، بين الفن والموقف الإنساني. كما تماثل من قبل مضمون فنه مع شكله وأسلوبه.
وكانت مقالة ناجى عن الحركة السيريالية المصرية هى آخر ما قرأت له. وهو يتشابه معها فى كثير من منطلقاتها وممارساتها وأفكارها.. ولكن أتمنى أن لا يكون المصير متشابها هو الآخر: النفى والتهميش والنسيان..
كانت الرواية هى المضمار الذى اختاره ناجى ليمارس حريته إلى أقصى درجة ممكنة، ويقدم ممارسته الثورية الأصيلة، وهو بذلك يعيد إلينا بعضا من إيماننا بالكتابة وجدوى الكلمات، والحياة أيضا.
يُنشر هذا المحتوى في إطار حملة مشتركة بين مواقع “زائد 18″، و“مدى مصر”، و“قل”،و“زحمة“. للتضامن مع الروائي أحمد ناجي.